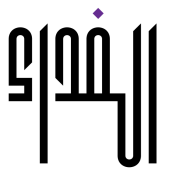زرت دمشق بالقريب، وكانت الأعمال تلاحقنا بسرعة، فنبض العاصمة لا يشبه غيره، لذلك كان الوقت يمضي مع صديقي بلهفة للانتقال من مكان لمكان ومن عمل لآخر، حتى غابت الشمس في العاصمة و فاح الياسمين عطراً، عندها دعاني صديقي دعوة غريبة جميلة، قديمة جديدة، حلوة عزيزة ، قال: ما رأيك أن ندخل لحضور فيلم في السينما، فوافقت بلا تردد مع فرحة تشبه فرحة الأطفال، وبدأت الراحة تتسلل لأوصالي المتعبة في لحظة إطفاء أنوار صالة السينما لمتابعة الفيلم، وعصفت الأفكار الجميلة في جمجمتي المخدرة حبا و حنيناً للفنون كافة، و للبلد أولاً، فتذكرت أولى المحاولات للعرض السينمائي عام 1895 بيدي الأخوين لوميير، وما جر الزمان في تفسير وتوضيح (لرفاعة) ونبالة الفن السابع، ففن السينما يفرض وجوده على شرائح المجتمع كافة، وهو أداة للتعبير عن كل خفايا النفس وما يحيط بها من أفعال ونتائج ، ولا يمكن لبلد لا يسعى لتطوير هذا الفن، أن يكون معافى و يثبت بصماته اللازمة للبناء والرقي، من ناحية ثانية تعد السينما عاملاً فاعلاً لتطوير وتنمية المجتمع وتنمية الذائقة العامة، وبتوفر الفيلم الممتاز يتهذب السلوك و ترق المشاعر، وهذه فسحة ضرورية لإعادة إعمار ما نفقده من مكنوننا دون انتباه، لذلك أشارت بعض الدراسات إلى أن السينما هي (مصنع الأحلام)، حيث نترك نفسنا للاندماج بأحلام طائرة أثناء متابعة الشاشة العملاقة داخل الظلام المحبب، وهي راحة نسعى إليها جميعنا، ومن هنا تظهر أهمية الحفاظ على العاملين بمجالات الفنون كافة، لأن كل الفنون الممتازة والمدروسة هي ثقافة خاصة بأمتها التي أنتجتها، وتفتح نوافذ مشرعة لهواء جديد يطرد حالة الركود، وهذه هي دمشق، المدينة المعافاة، التي تطرد غبار الرتابة عن أكتافها يومياً، ولا تستكين عن الحب، ولا تنسى ما لها وما عليها، فهي الساعية للقمم دوماً، ولا يطال قاسيون إلا هي، ولا بد أن نذكر أن السينما هي صناعة فائقة التأثير في الدخل الوطني وداعمة لكل زاوية في اقتصادنا الذاتي، وشهدت حماة خلال تاريخها نهضات فنية جميلة، وحاليا تحتضن أشخاصاً يعملون بصدق لتطوير الفنون عامة والسينما خاصة.
شريف اليازجي